(نُشرت نسخة أولى من هذه المقالة في صحيفة التحرير في ٥ ديسمبر ٢٠١٣ وللأسف لا يوجد للصحيفة أرشيف الكتروني متاح، وتم تحديث بعض المعلومات في هذه النسخة)
منذ ١١ سبتمبر ٢٠٠١، يجتمع أمن إسرائيل وحماية تدفق النفط الخليجي ومحاربة الإرهاب كلها تحت مظلة واحدة بالنسبة لفريق المدرسة الواقعية في وزارة الخارجية والدفاع الأمريكيتين وهي مظلة الاستقرار الإقليمي التي تضمن عمل أجهزة الأمن ضد أي عنف مسلح ومنظم قد يحمل في طياته مشروعا سياسيا مناونا للمصالح الأمريكية. ولضمان مثل هذا الاستقرار الإقليمي تغاضت الولايات المتحدة عن ممارسات نظم حكم عربية عديدة تميزت بالانتهاكات المنتظمة لحقوق المعارضين والأقليات إضافة إلى الفساد المنظم الذي حرم أغلبية الشعوب من أي ثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهيمنت وزارة الدفاع تدريجيا على وضع السياسات التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية الثلاثة مقارنة بوزارة الخارجية الأضعف والأقل أهمية. ويري فالي نصر، المرتحل بين أروقة الدبلوماسية وكلية الدراسات الدولية المتقدمة في واشنطن، أن دعم النظم الديكتاتورية الحاكمة في الشرق الأوسط كان دائما في القلب من سياسة الولايات المتحدة في المنطقة ولكن الأثار الجانبية لهذه السياسة بدأ يفوق العائد منها حيث افرزت هذه النظم ذات المشاكل التي كانت الولايات المتحدة تؤيدهم من أجل احتوائها في المقام الأول، فصارت النظم المكلفة بضمان الاستقرار هي منبع الاضطراب. وعلى سبيل المثال خرج معظم ارهابيو الهجمات على مركز التجارة العالمي وقيادات القاعدة من السعودية ومصر واليمن وليبيا والأردن.

انهت تلك الهجمات الدموية عقد التسعينيات، سنوات الاحلام الامريكية الكبرى، عندما ساد شعور أن واشنطن صارت سيدة العالم وباتت شعوب ودول شتى ترنو بشغف إلى ثقافتها وعلمها ونظامها الليبرالي الرأسمالي. وتغنى معلقون أمريكيون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بنهاية التاريخ وبداية عصر السلام الأمريكي والهيمنة الفائقة لواشنطن في عالم أحادي القطبية. وترنحت سنوات الدعة والاحلام مع أزمات اقتصادية عالمية وامريكية في نهاية التسعينيات وتلاشت مع غبار برجي مركز التجارة، لتنفتح اروقة السلطة السياسية تماما امام فصيل قوي كامن لم يختف قط في الميدان السياسي الامريكي. وهكذا بالنسبة لصانعي السياسة الخارجية الامريكية لم يتنته التاريخ كما بشرهم فرانسيس فوكوياما بل دخل في مرحلة صراع جديدة كما أنذرهم صامويل هنتجتون. وتلقفت مجموعة نافذة من المحافظين الجدد الكرة، وكان بين المحمومين باللعبة الجديدة نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوويتز.
وهكذا بالنسبة لصانعي السياسة الخارجية الامريكية لم يتنته التاريخ كما بشرهم فرانسيس فوكوياما بل دخل في مرحلة صراع جديدة كما أنذرهم صامويل هنتجتون.

وهكذا كانت هجمات سبتمبر علامة فارقة لأنها ولسنوات عديدة مدمرة منحت المحافظين الجدد فرصة لتطبيق أفكارهم في السياسة الخارجية الامريكية وفهمهم المحدد لكيفية خوض الصراع الكوني بما يشمل اغلاق الهوة المفترضة بين المصالح والقيم الامريكية في الشرق الاوسط. وصار العراق ضحية مزدوجة، أولا لمغامرات طاغيته صدام حسين وثانيا لخطط المحافظين الجدد الجهنمية والتي معها صارت الديمقراطية ونشرها سلاحًا في ترسانة مؤسسة الأمن القومي الأمريكية من أجل ضمان الاستقرار الاقليمي في المنطقة على المدي الطويل.وبدأ الضغط على الحلفاء الأكثر ضعفا وفي مقدمتهم مصر المعتمدة على الخارج كثيرا من أجل التحول نحو الديمقراطية وتدعيم أسس اقتصاد السوق.
وحتى ذلك الوقت، كانت الأصوات المسيطرة على السياسة الخارجية في واشنطن تدعو في أفضل الأحوال إلى انتقال تدريجي وطويل الأمد نحو الديمقراطية في المنطقة. وكان هذا بدوره خبلاً من نوع اخر إذ كان المؤيدين لهذا الاتجاه يفترضون أن القائمين على والمستفيدين من بقاء النظم السلطوية وفسادها وقمعها هم أنفسهم من سيقومون بقيادة التحول للديمقراطية. بل واعتقد بعض المنظرين لما صار يُطلق عليه علم “التحول” او الانتقال الديمقراطي في اقسام العلوم السياسية الامريكية أنه يمكن تحفيز وخلق مثل هذا التحول عن طريق تقديم دعم تافه لمنظمات المجتمع المدني أو تنظيم برامج تدريب مشكوك في فعالياتها لمؤسسات الدولة وموظفيها بما يتضمن إرسال آلاف من هؤلاء الموظفين والعسكريين في بعثات تعليمية أو وضع برامج إصلاح هيكلي (لا تنفذ قط) لمؤسسات الأمن والعدالة والتعليم والصحة. كل هذا الدعم كان ماليا ومعنويا هامشيا ولا أثر كبيرًا له مقارنة بالدعم الضخم سياسيا وأمنيا وعسكريًا واقتصاديًا للنظم القائمة وسياساتها المعتادة. بالنسبة للمحافظين الجدد امتزج الترغيب بالترهيب باستعمال القوة الفعلي لنشر الديمقراطية بصورة معينة.
كانت الأصوات المسيطرة على السياسة الخارجية في واشنطن تدعو في أفضل الأحوال إلى انتقال تدريجي وطويل الأمد نحو الديمقراطية في المنطقة. وكان هذا بدوره خبلاً من نوع اخر إذ كان المؤيدين لهذا الاتجاه يفترضون أن القائمين على والمستفيدين من بقاء النظم السلطوية وفسادها وقمعها هم أنفسهم من سيقومون بقيادة التحول للديمقراطية
ولذا لم يكن نشر الديمقراطية مجرد غطاء وهمي لتسويغ غزو العراق في ٢٠٠٣، فمجموعة الدوافع كلها لهذه الحرب الاختيارية كانت مجموعة أوهام مركبة، وتساوى نشر الديمقراطية في هذا مع القضاء على أسلحة دمار شامل (لم يكن وجودها مؤكدا ولم يجدوها بعد الغزو) او القضاء على دعم العراق للارهاب (وهو البلد الذي صار مصدرا هائلا للارهاب بعد الغزو). وبعد غزو العراق، أعلنت واشنطن عن مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط لنشر الديمقراطية وسريعا ما صارت هذه المبادرة محل انتقادات واسعة بسبب غياب الرؤية وعدم فرض أي شروط جدية أو منح محفزات ضخمة وحقيقية للحكومات من أجل الإصلاح الديمقراطي. وذهبت معظم أموال هذه المبادرة حتى اندلاع الثورات العربية إلى متلقيها عبر الحكومات نفسها التي تعين أن توافق أيضا على المشاريع المموّلة.
وكان التصور الاجرائي للديمقراطية على انها مجرد انتخابات وصناديق تسمح بتداول السلطة ولكن داخل اطار مقبول أمريكيا هو التناقض الهيكلي الثاني في أفكار المحافظين الجدد. وفضحت ديمقراطية الصناديق هذه التناقضات بين دوافع ووسائل وتصورات الإدارة الامريكية، ففي مصر حصل الإخوان في جولة انتخابات أولي في ٢٠٠٥ على عشرين في المائة من مقاعد البرلمان بينما حصد إسلاميون مقربون للإخوان معظم مقاعد البرلمان الفلسطيني.

لم يكن الأمريكيون قد قرروا التعامل بصورة جدية مع الإخوان المسلمين كفصيل سياسي يمكنه تولي السلطة في أي بلد في المنطقة. ولا يعني هذا ان تلك الفكرة لم تكن مطروحة حيث حاجج عدد من المسؤولين والباحثين الامريكيين أن مشاركة الاخوان في السلطة سيمنح واشنطن حليفا ناجعا في مواجهة حركات الإسلام السياسي العنيفة وينزع البساط الجماهيري وقدرات الحشد من تحت اقدام الجهاديين والقاعدة. وتدعم موقف هذا الفريق اكثر وبسرعة مع اعتقاد متنام أن الإخوان المسلمين سيصطفون مع السنة ضد الشيعة في مواجهة تسارع اختمارها بين السعودية وحلفاوها العرب في الخليج من ناحية وإيران من الناحية الأخرى. ولم يتمكن هذا الفريق ابدا من فرض تصوره مع تلاحق أزمات متتالية تطلبت تأمين دعم النظم القائمة في دول مثل مصر والأردن وليبيا (استمرار التدهور الأمني في العراق، فوز حماس الانتخابي ثم سيطرتها على غزة، حرب إسرائيل وحزب الله في 2006 ثم تصاعد حدة الأزمة الإيرانية/السعودية مع تمدد النفوذ الإيراني في العراق ولبنان).
وتوقف مشروع نشر الديمقراطية بحلول عام 2007 وإن ظلت بعض الأصوات في واشنطن تدعم السعي من أجل التحول الديمقراطي في المنطقة بغرض خدمة الامن القومي الأمريكي. وقدمت تامار كوفمان ويتيس الباحثة في معهد بروكنجز أكثر الحجج تماسكا في هذا المضمار في كتاب لها صدر عام 2008 بعنوان “المسيرة المهتزة للديمقراطية: دور أمريكا في بناء الديمقراطية العربية” – Freedom’s Unsteady March: America’s Role in Building Arab Democracy وحاولت كوفمان ويتيس تشبيك المصالح الاستراتيجية الأمريكية مع قيمها وادعت أن التحول الديمقراطي فقط يمكن أن يضمن دعما مستمرا للمصالح الأمريكية حيث أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على طغاة أقوياء لضمان تعاون دول المنطقة في وجه السخط الشعبي المتزايد.
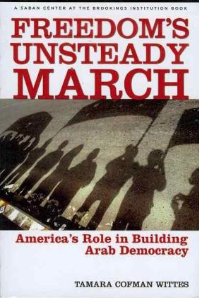
كانت الأنظمة الديكتاتورية من وجهة النظر هذه ملائمة في فترة الحرب الباردة ومن أجل أهدافها ولكنها صارت عاجزة أمام تحديات جديدة في الدول العربية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. فقد وقفت أنظمة مبارك والقذافي مثلا عاجزة عن الوقوف في وجه تزايد أنشطة تهريب البشر والسلاح عبر أراضيهما وعجزوا عن التعامل المرضي مع أزمات اللاجئين. كان القذافي يلقي بالمهاجرين غير الشرعيين في سجون مروعة ويستعملهم أوراق ضغط بينما كانت تدخلاته الغريبة في أفريقيا مصدرا لتمويل حروب أهلية واضطرابات عرقية مختلفة. وكان نظام مبارك يظهر إخفاقا متزايدا في منع تهريب البشر والسلاح من شرق أفريقيا عبر الأراضي المصرية بينما أخفقت قوات أمن مبارك في فض احتجاج لاجئين سودانيين بشكل معقول وافرطت في استعمال القوة فقتلت 27 منهم 11 طفلا في عام 2005 في ميدان مصطفي محمود بحي المهندسين. والأهم كانت قناعة متزايدة في واشنطن أن هذه النظم فشلت في تجفيف منابع الإرهاب، فرغم أنها كانت طيّعة في معاونة الأمريكيين في الاعتقال غير القانوني والتعذيب وانتزاع الاعترافات والقيام بما تعجز الحكومة الأمريكية عن القيام به على أراضيها أو حتى في معتقل جوانتانامو الا أن هذا كله لم يوقف تزايد مشاعر العداء الشعبي للأمريكان وتمدد الدعم، المعنوي على الأقل، لأيديولوجية القاعدة والجهاد الإسلامي المسلح وسط الشعوب العربية.
اعتقد بوش ومحافظوه الجدد وبعض الليبراليين في واشنطن أن إصلاح النظم الديكتاتورية وجعلها أكثر كفاءة يمكن أن يجفف نبعا أصيلا للإرهاب ويخفف من غلواء العداء الشعبي المتزايد للولايات المتحدة. وافقت كوفمان ويتيس على سياسة بوش ولكنها انتقدت الوسائل المتتبعة في تنفيذها حيث رأت أنها لم تكن ملائمة ماليًا أو سياسيًا. بالنسبة لها كانت الأيام قد أكملت دورتها ولم تعد الصفقة القديمة صالحة. كانت الصفقة التي استمرت منذ منتصف الأربعينيات مع السعودية ومنتصف السبعينيات مع مصر على سبيل المثال بسيطة: “يقوم الديكتاتور بفعل ما تريده أمريكا بشكل ما أو بآخر مقابل التغاضي الأمريكي عن القمع المحلى. “ولكن الأمور تغيرت، لأسباب عديدة منها بالأساس فشل هؤلاء الطغاة المتزايد في تلبية احتياجات شعوبهم المادية مع تزايد الضغوط الاقتصادية الدولية وتكلفة مدفوعات الفساد المحلية على خزائنهم الصغيرة. تغيرت الأمور وصارت كوفمان ويتيس ورفاقها من معسكر دعم الديمقراطية يعتقدون أن مخاطر “التحول الديمقراطي في العالم العربي مقبولة بل ويقل ثمنها عما سيتعين أن ندفعه في الأغلب إذا لم يحدث التحول الديمقراطي في هذا الموقع الاستراتيجي من العالم”. وفي عام 2009 صارت ويتيس مساعدة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كيلنتون لشئون الشرق الأدنى. ولكن السياسة الأمريكية لم تتغير كثيرًا على الأقل علنًا.
اعتقد بوش ومحافظوه الجدد وبعض الليبراليين في واشنطن أن إصلاح النظم الديكتاتورية وجعلها أكثر كفاءة يمكن أن يجفف نبعا أصيلا للإرهاب ويخفف من غلواء العداء الشعبي المتزايد للولايات المتحدة
لم تستطع الولايات المتحدة في معظم الوقت الحفاظ على مصالح نخبها في الشرق الأوسط دون خيانة بعض أو كل قيمها المدعاة، وعندما حاولت نشر الديمقراطية في المنطقة تحت قيادة بوش كانت المحاولة سطحية وتعاني من تناقضات متعددة ولم تعمّر كثيرًا.

عندما فكر الرئيس باراك أوباما في أن يلقي خطابا للمسلمين والعرب في عام 2009 قرر بعد تفكير ان يكون خطابه من القاهرة وأن يكون من تحت قبة جامعتها. كانت الأفكار المبدئية التي ناقشها مع كاتب خطاباته الشاب جون فافرو تحتوي توجيه رسائل واضحة قدر الإمكان لحكام دخلوا أرذل العمر مثل مبارك في القاهرة وعبد الله في الرياض وتكلست أنظمتهم. وكانت الرسالة الرئيسية أن الدعم الأمريكي لن يستمر للأبد وأنهم في حاجة للتغيير. ولكن مثل وعده بإغلاق معتقل جوانتامو وغيرها من تعهداته الانتخابية أثناء حملته في عام 2008 كان التنفيذ أقل من الأحلام، بكثير. لم يكتب فافرو (وكان عمره وقتها 28 سنة) أو يتحدث أوباما (وكان عمره وقتها 48 سنة) عن الحاجة للتغيير وضخ دماء جديدة في شرايين النظم العربية الديكتاتورية (بل وتغيير بعض هذه الشرايين كلية). واقتصر أوباما في خطاب القاهرة على تأكيد تمايزه عن بوش وأنه ليس مهتما بفرض أي تغييرات في نظم الحكم “من خارجها” بل أنه يفضل أن تكون التحولات نابعة من الداخل وأن يستمر العمل من أجل انتخابات نزيهة ومحاسبة المسئولين واحترام حقوق الإنسان إلى آخر قائمة أسس الدولة الرأسمالية الحديثة والاحلام الحقوقية التي تظل في خانة الاماني والنضال طويل الاجل ما لم تجد رافعة سياسية تحملها وتفرضها.

وتخيًر أوباما كبيرا لمستشاريه لشئون الشرق الأوسط دبلوماسيا اشتهر بالواقعية والحنكة وهو دنيس روس الذي كان وسيطا أمريكيا لعملية السلام الإقليمية المتعثرة لسنوات وإن ظل بين مستشاريه الآخرين من يدافعون بشدة عن أجندة للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان بصفتها جزء أصيل من المصالح الوطنية. وتقدم هؤلاء المستشارين المازجين بين المثالية وبعض الواقعية سامانتا باور التي عملت في مجلس الأمن القومي ثم عُينت سفيرة الولايات المتحدة للأمم المتحدة. ولباور تاريخ طويل في الدفاع عن “حق التدخل الإنساني” ويعني منح الحكومات حق التدخل في دولة بعينها لحماية فئات واسعة من شعبها إذا تهددها خطر داهم طالما كانت الدولة القائمة عاجزة عن او غير راغبة في حماية هذه الفئات (أو طبعا تقوم بنفسها على ارتكاب هذه الانتهاكات). وألفت باور منذ ان كانت تعمل بالصحافة عدة كتب ودراسات لدعم مفاهيم وسبل تفعيل “حق التدخل الإنساني” وخاصة بعد مذبحة رواندا في ١٩٩٤ قبل أن تترك الصحافة وتعمل بالتدريس في جامعة هارفارد ثم تعاون أوباما في حملته الانتخابية حتى نجح وضمها لفريقه في البيت الأبيض. وسيكون لباور دورا مهما في قصف حلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لليبيا في غمار الانتفاضة الشعبية على القذافي هناك في ٢٠١١.
وفي التحليل النهائي رغب أوباما وإدارته في إنجاز تحول ديمقراطي وتأكيد ودعم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ولكنهم لم يفعلوا شيئًا محددا من أجل هذا الهدف وركزت سياساتهم الفعلية على حماية مصالح مادية وسياسية رئيسية هي النفط وخاصة السعودي والأمن وخاصة الإسرائيلي.
وفي التحليل النهائي رغب أوباما وإدارته في إنجاز تحول ديمقراطي وتأكيد ودعم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط ولكنهم لم يفعلوا شيئًا محددا من أجل هذا الهدف وركزت سياساتهم الفعلية على حماية مصالح مادية وسياسية رئيسية هي النفط وخاصة السعودي والأمن وخاصة الإسرائيلي. ولم تتلقي النظم الديكتاتورية في دول الصف الثاني من حيث الأهمية الإستراتيجية (مصر والأردن وتونس وغيرهم) أي تحذيرات أو رسائل عن عواقب من أي نوع إذا استمرت سياساتها القمعية. وحتى الوعود التقنية التي قدمها أوباما في خطاب القاهرة حول تقديم دعم مالي وتكنولوجي وتوسيع برامج استقدام الطلاب للدراسة في الولايات المتحدة وفتح مزيد من فرص البيزنس مع البلدان في العالم الإسلامي لم يتم الوفاء بها.

خلق انتخاب أوباما فورة من التوقعات المثالية في أنحاء العالم لدرجة أنه حصل على جائزة نوبل للسلام قبل أن يكمل عامه الأول في الحكم ويظهر لسياساته أي أثر حقيقي على أرض الواقع. تسلم أوباما الجائزة والحرب مستمرة في أفغانستان والعراق ومعتقل جوانتانامو يأوي مئات الأشخاص المعلقين في أرض بلا قانون، وكأنما كانت الجائزة تحية لأوباما وتعبيرا عن الفرحة بانتهاء عصر بوش وبالتالي تربية الأمل في انتهاء قريب لحروب الولايات المتحدة الفاشلة في الشرق الأوسط وأسيا وانتهاكاتها التي باتت منتظمة لحقوق الإنسان. ولكن أوباما كان في سلوكه مثالا جديدا على الواقعية في السياسة الامريكية (وربما أكثر واقعية من بوش نفسه) ولذا تهاوت في السنوات التالية لاحتفال الجائزة معظم الأحلام والتوقعات الخاصة بدعم حقيقي من واشنطن للتحول الديمقراطي في الشرق الأوسط، وهو التحول الذي لم يفكر صانعوه أبدا في معضلة الدولة العنصرية الوحيدة القائمة في المنطقة، وهي إسرائيل.

وفي أغسطس 2010 طلب البيت الأبيض من مجموعة من الخبراء إعداد دراسة عن استقرار الأنظمة في الشرق الأوسط. وخلص التقرير، مرة أخرى، إلى أهمية دعم تحول ديمقراطي تدريجي وإجراء إصلاحات والعمل أكثر مع المجتمع المدني والمسئولين الراغبين في الإصلاح. ولكنها أيضا أكدت أن الضغط على هذه النظم لن يفيد وأن معظمها سيلجأ للقمع والعنف للتعامل مع أي اضطرابات سياسية أو اجتماعية تطالب بالإصلاح. ولم ينظر التقرير في حالة تونس التي كانت أول قطع الدومينو الساقطة في الثورات العربية بعد ذلك بشهور معدودة. وانتهى التقرير في خاتمته الرئيسية إلى أن “الجيل العجوز من الطغاة يجب أن يموت أولا قبل أن تشهد المنطقة أي انفتاح سياسي كبير”. ولم يتمخض عن هذه الدراسة الضخمة أي قرارات فعلية أو تغيير يُذكر في السياسة الأمريكية. لم تتوقع الإدارة أي تحولات كبيرة في المنطقة وكانت منشغلة أكثر بإيران والتعامل مع الصين وإعادة محورّة العلاقات مع جنوب شرق آسيا وإكمال الانسحاب المحسوب من العراق وأفغانستان في السنوات التالية. لم يكن بالشرق الأوسط أي نذر حقيقية على تحول السخط والغضب والإحباط السائد بين فئات الشعب الفقيرة والمتوسطة أو تلك الطامحة في التحديث والتغيير (أو تطبيق الشريعة والعودة لعصر ذهبى) إلى ثورة تهدد الاستقرار.
وحتي بعد انتخابات البرلمان المزورة بفداحة في مصر في نوفمبر 2010 لم تتوقع الإدارة ردود فعل شعبية غاضبة. والتقي دنيس روس مع مجموعة من الباحثين المختصين بمصر في معاهد الأبحاث في واشنطن وقتها. وقال لي أحدهم: “كانت الإدارة مشمئزة من انتخابات نوفمبر الفاسدة للغاية… وأصدروا بيانا صحفيا ليعبروا عن امتعاضهم إزاء مبارك… كانت هناك خلافات داخل الإدارة وكان بعض العاملين غير سعداء بالسياسة المتبناة ولكن لم يكن هناك أي شعور بالعجلة”.
ومثل إدارات أخري سابقة، بدت إدارة أوباما عاجزة عن الاختيار بين المصالح
والقيم وكأنهما أمران متناقضان لا يستقيم أحدهما مع الآخر وجرت التضحية سريعا
بأحلام الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من أجل الضمان الوقتي والمؤقت لتدفق النفط
وأمن إسرائيل وتوسيع الحرب على الأرهاب، وهي تضحية كانت تستلزم دفع اثمان متزايدة
مع مرور الوقت.

